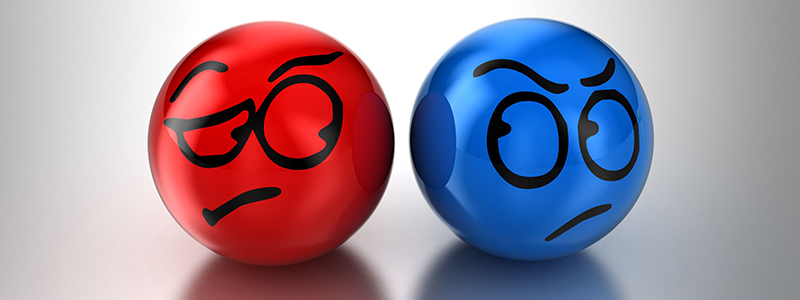
من يقرأ حديث رسول الله (ص) اختلاف أمتي رحمة ويعاين حال الأمة، و حال مجتمعاتنا، وما نحن فيه في هذه الرقعة الصغيرة فلا بد أن يحتار ويتساءل أيهما هو الصحيح، أهذا الحديث الشريف أم واقع الحال الذي يشي بأن واقع الاختلاف ما هو إلا نقمة محضة!. جدير بالذكر أننا نقول ذلك لا تشكيكًا في صحة الحديث ونسبته للرسول “ص” وإنما استفزازًا واعيًا للعقل، وامتحانًا لما نؤمن به جميعًا، فنحن المسلمين من ندعي انتماءنا لأمته (ص)، وندّعي أننا نهتدي بهديه ونستن بسنته، فدعونا نتأمل في شخصية القائل وزمان المقولة ومكانها لعل الذكرى تنفعنا جميعًا.
قالها الصادق الأمين وهو أكثر الناس رأفة و محبة لخلق الله، فهو الهادي للناس و مخرجهم من الظلمات إلى النور، قالها وهو الذي عانى من اختلاف أهله وعشيرته معه على ما حمله لهم من خير الدنيا والآخرة، وعانى “ص” من هذا الاختلاف الكثيرَ الكثير في نفسه و أهله وعياله ورسالته وأنصار رسالته التي حملها للناس كافة، قالها و هو العارف بأمته وما ستؤول له من بعده ليفتح لهم باب رحمة وألفة وتطوير، لأنه يريد أن يخط لهم قيم فهم الاختلاف، وطريق ممارسته ممارسة صحيحة، ويهديهم إلى الانتفاع من الاختلاف لتطوير ذواتهم ومجتمعاتهم،والسير لما فيه الخير والصلاح، وليضرب لهم طريقًا للرقي و التقدم عبر تلاقح الآراء المختلفة والمتعارضة وصولاً لاختيار أقربها صلاحًا، كل ذلك لما فيه خير الأفراد والجماعة فهل لنا أن نتساءل أو نشكك في صدق هذه المقولة، كلا طبعًا، بل إن الحكمة تقتضي أن نُعمل العقل للتدبر في مكنونها وجوهرها لاستلهام العبر والدروس، لتكون لنا هاديًا و معلمًا ينير طريق الحياة كلما ادلهم، ويكشف لنا جوانبها المضيئة لنبني معًا أوطانًا عزيزة ناهضة، لا أن نظل نتخبط في ظلمات الخلاف و نصر على استكمال المسير في طريق التراجع و الانتكاس.
عانت الأمة ومنها بلدنا، وتفرقت الشعوب إلى فرق عدة، حتى ساد التناحر و التنافر بينها، وتعطلت قدرات الفرق جميعها، و أضحت شعوبنا وأمتنا في آخر ركب الأمم، لأننا استنفذنا إمكاناتنا وقدرات هذه الأمة في الصراع، ليثبت كل فريق بأنه على حق وما خلاه من المخالفين على ضلال، كلٌ يدعي أنه الفرقة الناجية، والآخرين حطب نار جنهم، وكأني بهم في قرارة أنفسهم استصغروا الجنة التي قال عنها المولى واصفًا سعتها بأنها “عرض السموات والأرض”، فلم يتخيلوها متسعة إلا ليسكنوها هم وحدهم فقط، ولا مكان لغيرهم فيها نتيجة فهم معوج لمقولة نبي الرحمة.
اختلاف أمتي رحمة ليس بالفهم العسكري الدموي الذي مورس في مجتماعتنا على مدى عهود، وإنَّما بالفهم العقلي المنطقي الذي حث عليه الخالق وثبته في قرآنه في أكثر من موضع ( يتفكرون .. يعقلون .. يتذكرون) ممزوجًا بروحية التسامح العظيمة التي مارسها نبي الرحمة قبل وبعد فتح مكة، تلك الروحية التي ألفت بين القلوب المتباغضة، ومكنت المسلمين الأوائل من الوصول إلى أقاصي الأرض لنشر الرحمة والهداية للإنسانية جمعاء، فإذا امتزج الاختلاف بالرحمة والتسامح، وبحقيقة استحالة وجود نظرة أحادية شاملة تستطيع تفسير جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسة والاقتصادية، وإن جميع الاختلافات ما هي إلا اختلافات في الكم والكيف، ولا يكون الناس عقلاء إلا بقدر استيعاب أن ادعاء امتلاك الحقيقة كاملة هو عين الجهل والضلال، فالعاقل حينما يعي هذا ويستحضره في نظرته للآخر وتعامله معه يدرك أنه مكون ما في فسيفساء كبيرة اسمها الأمة، فيلتمس لجميع مكوناتها أوجه صواب رأيها ويتسامح مع خطأ ما ذهبت إليه في فكرها، هكذا يصبح العقل هو ما يوحد الناس على جامع مشترك، في حين أن الفهم والرأي حصيلة فكر ونظر واختلافنا فيه وارد ومحمود مادام في حدود صحيحة منضبطة لا تجعل أحدنا يبغي على الآخر.
اختلاف أمتي رحمة بالفهم العقلي المنطقي وبروحية شراكة الحاضر والمستقبل كوسيلة فاعلة لإحداث أثر في وجودنا، ودرع حماية للحد من الصدمات العنيفة المتكررة في مجتمعنا، فهذا الاختلاف يزيل الضباب المتراكم للكثير من المواقف والآراء المشكلة، ويجنبنا تزيين ما نحيكه لبعضنا، وما نضعه من مطبات وبرامج للإيقاع بالآخر، لأجل الانتصار عليه نتيجة لشك مصطنع، أو فهم مغلوط أو خوف لا أساس له في أرض الواقع.
الحديث الشريف وسيلة فعالة لاستنهاض همتنا لنحيا القيم التي تآكلت بفعل التناحر والاحتراب، ولانحرافنا عن فهم سنة الاختلاف حتى تحولت نقمة علينا بعد أن كان الرسول أسس لها لتكون رحمة، وما كان ذلك ليحصل لو أن أجيال الأمة استوعبت أن طريق التطور كان دائما و لا يزال يمر عبر سلسلة طويلة من حالات التأثر والتأثير السلبي والايجابي معًا، وأنه وسيلة لحفظ القيم وعدم تآكلها وتصفيتها، فالأشياء تُعرف بأضدادها، والقناعة بالخير والتطور ترسخ في العقل والممارسة إذا لمسنا وعاينا نتاج الشر والجمود كما هو حالنا اليوم، ولكن عجبي على أمة تعاين حصاد اختلافها اقتتالا وفرقة ولا تتيقن أنها تمشي إلى الوراء وهي تهوي وتنحدر من علياء مقامها.
لا أدعي الكمال في ممارسة الحديث الشريف، ولا القدرة على فهم ما لا يستطيع الآخرون فهمه ولا اكتشاف الجديد و لكنها ذكرى لعلها تنفعني وتنفع آخرين، وتذكر بما قد نسي في غمرة انشغالنا بمعاركنا البينية.


