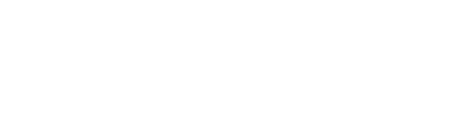الاختلاف شيءٌ طبيعي جُبل عليه بنو البشر، وقد خلق الله عزّ وجلّ الناس مختلفين ولا يزالون كذلك (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ)(هود:118)، ولن تجدَ قوماً يتفقون تمام الاتفاق في كل شيء، سواءً في الأفكار والتوجهات أو الميول والرغبات أو الاهتمامات أو غيرها، وذلك لاختلاف ظروف التنشئة بين الأفراد واختلاف مستوياتهم في الفهم والاستيعاب والقدرات، والواقع شاهدٌ على ذلك حتى أنّك تجد أصحاب الدين الواحد والكتاب الواحد والقبلة الواحدة واللغة الواحدة، بل وأصحاب المذهب الواحد يختلفون بدرجات تكبر أو تصغر في الكثير من المسائل المتعلقة بالدين أو الدنيا على السواء، وقد يصل الاختلاف أحيانا في بعض المسائل الدينية إلى حد التناقض التام كقول فريقٍ بحرمة الشيء وقول الفريق الآخر بحليته! فما هو الحل إذن لاستيعاب الاختلاف ودرء التصادم بين المختلفين؟ وهل من سبيل لتوظيف هذا الاختلاف للاستفادة منه في توسعة العقول والصدور حتى يغدو رحمةً للناس لا نقمة كما هو الحاصل في الوقت الحاضر؟
إنّ الحل يكمن في النظر إلى الاختلاف والتنوّع كآية من آيات الله سبحانه وابداعاته في خلقه، أضفى بها على الوجود رونقاً وجمالاً كُنّا حُرمناه لولا وجود ذلك الكم الهائل من التعدّد والتنوّع والاختلاف في الألوان والهيئات والأشكال التي اتسمت بها عوالم المادة والنبات والطير والحيوان، ولم يشذ عن تلك القاعدة عالم الإنسان أيضا (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِلْعَالِمِينَ)(الروم:22)، وما كان اختلاف الألسن والألوان كمظهر خارجي طبيعي إلا ترشّحاً عن اختلافٍ في الثقافات والحضارات والجغرافيا، وقد جعل الله سبحانه هذا الاختلاف مادةً للتواصل والتلاقح المعرفي والاجتماعي بين بني الإنسان لا مدعاةً للتمايز والتباغض والتحارب (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)(الحجرات: 13)، ولا يتم ذلك إلا عبر التلاقي والحوار.
فإذا كان الحوار مطلوباً لتحقيق التعارف المنشود بين بني الإنسان كافة بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم وأعراقهم وأوطانهم، فكيف به بين أصحاب الوطن الواحد الذين يتشاركون همومه ويتقاسمون مسئولية بنائه والحفاظ عليه، أليس الأحرى بهم أن يتآلفوا ويتحدوا ويتعاونوا على صيانة هذا الوطن والنهوض به وإن اختلفوا في رؤاهم واطروحاتهم لتحقيق ذلك الهدف بناءً على اختلاف ايديولوجياتهم؟ بلى، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتلاقي والحوار لاختيار المناسب من الحلول لتذليل العقبات التي تعترض تحقيق السلم الأهلي والعيش المشترك، ولكي يتحقق ذلك لابد أولاً من حل الاشكالية في جذورها الثقافية، أي كيف ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين أصحاب الأديان والمذاهب المختلفة وبين المؤمنين وغيرهم، وهل هي علاقة تباغض وتحارب أم علاقة تعايش وتعاون؟ بحيث يُصار إلى تصحيح النظرة إلى الآخر المختلف فكراً أو مذهباً أو ديناً، فيتم الاعتراف له بحقه في الوجود والمشاركة، بل والتعاطي الايجابي معه في الشأن الوطني المشترك دون تهميش أو إقصاء بسبب الاختلاف في الرأي أو المذهب أو الدين، فسفينة الوطن ينبغي أن تسع الجميع ويجب المحافظة عليها من قبل الجميع.
لقد أقرّ الله سبحانه لغير المؤمنين به حقهم في الوجود ولم يمنع عطاءه عن الكافرين، وأجرى الأسباب الطبيعية عليهم وعلى المؤمنين بالسواء ولم يعلقها على الإيمان به فقال تعالى: (كُلّاً نُمِدُّ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً)(الاسراء:20)، وأخّر حسابهم إلى يوم الحساب، ودعا المؤمنين إلى التعامل البار والعادل مع المسالمين منهم والتعايش السلمي معهم فقال تعالى: (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)(الممتحنة:8).
وكان التوجيه القرآني للرسول(ص) في هذا الصدد واضحاً وهو يضع القاعدة الأساس من قواعد أدب الحوار مع الآخر المختلف وهم المشركون الذين يختلفون معه في صلب العقيدة، أمَرَه بأن يطرح عليهم ما يراه صحيحاً حسب اعتقاده مع القبول بالنزول إلى مستوى احتمالية الخطأ ليكون هو والآخر عند ابتداء الحوار على قاعدة سواء، وليكشف لهم بالحجة والبرهان عبر آلية الحوار صحة ما يراه، ولهم بعد ذلك الأخذ به أو رده، قال تعالى مخاطباً رسوله (ص): (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ)(سـبأ:24)، ثم يشفع ذلك بما يؤكّد حسن النية تجاه الآخرين وعدم التشكيك في نواياهم بإصدار أحكام مسبقة، بل يذهب أبعد من ذلك احتراماً لمحاوريه حين يصف عمله في التقييم الأخروي عند الحساب بالإجرام اتهاماً للنفس، تاركاً وصف أعمالهم لحكم مَنْ يعلم النوايا وهو العليم بذات الصدور (قُلْ لا تُسْأَلونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ)(سـبأ:25).
فمرتكزات الحوار الناجح لابد أن تقوم على أسس ثابتة لا غنى له عنها وإلا صار كحوار الطرشان، أولُها: أن يقوم الحوار على قاعدة (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ)، فلا يدعي أيُ طرفٍ امتلاك الحقيقة كاملة أو احتكارها، يفعل ذلك لا من باب التكتيك والتصنّع الخارجي وإنما إيماناً عميقاً منه بهذه الحقيقة، وثانيها: الاحترام المتبادل بين الأطراف وتقديم حسن الظن والابتعاد عن شخصنة الموضوع باتهام المحاور في نيته أو النيل من شخصيته بدل التركيز على موضوع الحوار، وثالثها: تحديد المفاهيم وتعريفها عند الأطراف المتحاورة بحيث لا يكون عنوان الموضوع واحداً بينما معناه أو مصاديقه عند المتحاورين مختلفة.
معنى الحوار
الحوار هو المراجعة في الكلام من (يحور أي يرجع)، وفي القرآن الكريم: (إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ)(الانشقاق:14) أي يرجع، وقد سمّى القرآن الكريم في مَثَله المضروب الحديثَ الذي جرى بين الرجل الكافر وصاحبه المؤمن حواراً فقال: (وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً)(الكهف:34)، وبالمِثْل سمّى ردَّ صاحبه عليه فقال: (قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً)(الكهف:37)، فالحوار هو الوسيلة الوحيدة الناجعة للتعاطي مع الاختلاف في الآراء والمعتقدات وإنْ بلغ الاختلاف أقصاه كما في أمور العقيدة والإيمان بالله سبحانه، ففي هذه الآيات لم ينفِ الله عزّ وجلّ وجود الصحبة بين المؤمن والكافر ولم يستنكرها، فمن حق كل فرد أن يعتقد ما يشاء وإنْ عبد الحجر، ولمن خالفه الحق في إبداء النصيحة له بالتي هي أحسن ومحاورته في ذلك دون إكراه له على التخلي عن اعتقاده إلا أن يختار هو ذلك عن قناعة (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)(يونس:99). إذن فالحوار هو الحديث المتبادل أخذاً ورداً في الآراء والأفكار ووجهات النظر المختلفة بقصد التعريف أو التعارف في جو من الاحترام المتبادل بين طرفين أو أكثر كأندادٍ وليس بين طرفٍ قوي وآخر ضعيف يُفرض عليه الرأي بمنطق القوة لا بمنطق القناعة.
لماذا الحوار؟
في عالمنا العربي والإسلامي يغلب على أكثر المتحاورين في الشأن الثقافي والعقدي الرغبة في تحقيق الانتصار على الطرف الآخر، وذلك لأن العقلية التي تُدار بها تلك الحوارات عقليةٌ استعلائية ترى الحق من نصيبها هي فقط، أو عدائية تريد اخضاع الآخر وتركيعه لرؤاها دون الاعتبار لحرية فكره وعقيدته، ولن يجدي اقصاءُ الآخر أو إلغاؤه وشطبه من الواقع نفعاً في حل مشكلة الاختلاف، فهذا الأسلوب يزيد المشكلة تعقيداً والموقف تصعيداً وتطرّفاً، بينما هدف الحوار هو البحث عن الحقيقة المختلف عليها بمقابلة الأفكار بالأفكار والبراهين والأدلة ببعضها البعض حتى يحصل التغيير في القناعات وتتبدّل الأفكار دون ضغط أو إكراه، وقد يحصل ذلك أحياناً وقد لا يحصل أبداً ومع ذلك يبقى الحوار دليلا على التسامح وتقبّل الآخر بآرائه المختلفة وهو غاية ما يسعى إليه المجتمع للحفاظ على سلمه الأهلي وقيمه الإنسانية، لأن رفض الحوار يعني عدم القبول بالآخر وعدم احترام حريته وكرامته كإنسان وبالتالي عدم الاعتراف له بحق الوجود ما يهيئ الأرضية لخلق الخصومات الفكرية والعداوات العقدية المفضية إلى الاقتتال.
الاستماع جزء من الحوار
الحوار يبدأ أولاً بتوفير الفرصة لطرح الآراء المختلفة ولابد في المقابل من الاستماع لها، وهذه الفرصة هي حقٌ لجميع الأطراف ذات العلاقة دون تمييز إلا ما تمتاز به وجهة النظر أو الرأي بعد ذلك من قوة في الاستدلال والمنطق. حسن الاستماع هو جزء ضروري من عملية الحوار، ولقد ذمّ القرآن الكريم أسلوب سدّ الأسماع عمّا يقوله الآخرون بغرض عدم التأثّر به فقال عن قوم نوح (ع): (وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً)(نوح:7) وعن قوم شعيب(ع): (قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ)(هود:91) وعن قريش: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ)(فصلت:26)، بل دعا إلى عكسه تماما حين قال تعالى: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ)(الزمر: 18)، إذْ يُفترض بالإنسان المؤمن بأفكاره الواثق بصحتها أن لا يخشى طرحها ومواجهة الآخرين بها والدفاع عنها بأدلتها التي شيّد عليها إيمانه، وأن يتحلى بالشجاعة والمرونة الفكرية لتغييرها في حال اكتشف خطأها فالحكمة ضالة المؤمن أنّى وجدها اقتنصها.
لكل فرد كامل الحرية في التمسك بآرائه وإنْ خطّأها الآخرون سواءً أكان التمسك بها بسبب القناعة العقلية بصوابيتها أو لهوى نفسي يدفعه للاحتفاظ بها، طالما بقيت ضمن إطار الاختلاف لا تتجاوزه إلى التعدي والإضرار بالآخرين، وإن كانت الحكمة تقتضي في هذه الحالة تحكيم العقل والعمل وفق مقتضى المنطق ولو على حساب المصالح الآنية أوالاعتبارات الشخصية ولهذا قيل في الحِكَم: (العاقلُ يبدّل رأيه والجاهلُ عنود)، فالتمسك بالرأي الشخصي وبقوة لا يدل دائماً على صحته، فصحة الرأي تنبع من ذاته ومدى موافقته للحقيقة الموضوعية التي تكشف عنها البراهين المنطقية الصحيحة، أما قائله فلا يمكن أن يكون مقياساً للحق إلا أن يكون معصوماً من الخطأ، ولهذا قال الإمام علي(ع): (لا تعرفوا الحق بالرجال ولكن اعرفوا الرجال بالحق) وقال: (اعرف الحق تعرف أهله).
التسامح أولاً
القبول بالحوار مع الآخر لا يأتي إلا ثمرةً لما يتحلى به المتحاورون من التسامح وإلا أصبح الحوار شكلاً بلا مضمون، وأعنى بالتسامح هنا أن تسمح للآخرين بطرح أفكارهم وإن عارضت ما تؤمن به من فكر أو عقيدة، لهذا تجد في الكثير من الحوارات القرآنية التي دارت بين الأنبياء-صلوات الله وسلامه عليهم- وأقوامهم أو بين بعض المؤمنين وأصحابهم أو أقربائهم من غير المؤمنين تجد القدر العالي من التسامح والتلطّف وسعة الصدر وحسن الخلق التي يتصف بها هؤلاء المحاورون الذين ينشدون الإصلاح ويريدون الخير والهداية للآخرين، فهذا خليل الله إبراهيم (ع) يخاطب أباه بتلطف وتودد رغبةً منه في انقاذه من مغبة عبادة الأصنام، بأسلوب هو مزيج بين مخاطبة العقل واستثارة العاطفة، فهو من جهة يستثير فيه وشائج صلة الرحم بتكرار النداء (يَا أَبَتِ)، ومن جهة أخرى يخاطب عقله يستحثّه على التفكير بتهيئة المقدمات المنطقية الصحيحة للوصول إلى القرار السليم (يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً* يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً)(مريم:42-43)، ورغم الردّ القاسي وأسلوب التهديد والوعيد بالرجم لم يزدْ على أنْ قال: (سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً)(مريم:47). يفعل ذلك رغبةً في ايصال الخير للآخرين والأقربون هم أولى به، وربما تجاوزت تلك الرغبة أحياناً حدود الواجب في التبليغ لتصادر على الآخرين حريتهم في عقيدتهم، هنا تتدخل السماء لتضع الحد الفاصل بين أداء واجب التبليغ وبين حرية العقيدة (وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ)(آل عمران: الآية20)، جاء في المرويات أنّ إبراهيم الخليل (ع) كان لا يأكل الطعام وحده، فإذا حضر طعامه أرسل يطلب من يأكل معه، فلقي يوماً رجلاً فلما جلس معه للطعام قال له (ع): ألا تذكر اسم الله على ما تأكل؟ قال له الرجل: لا أدري ما الله!! فقال له إبراهيم (ع): اخرج عن طعامي، فلما خرج الرجل نزل إليه جبرئيل فقال له: يقول الله عز وجل: إنّه يرزقه على كفره مدى عمره، وأنت بخلت عليه بلقمة!
ذلك هو المنهج الرباني في التعاطي مع قضية الاختلاف في العقيدة والأفكار، لا يرفض أحداً إلا من بغى وظلم فهو مرفوض لظلمه وبغيه لا لعقيدته، ويبقى الحبلُ ممدوداً والبابُ مفتوحاً للتواصل والتعارف مع الآخر بل والتعاون على تحقيق المكتسبات الإنسانية من قيامٍ بالقسط وتطبيقٍ للعدالة وحفاظٍ على كرامة الإنسان التي باتت مهددة اليوم أكثر من أي وقت مضى بسبب عقيدته.