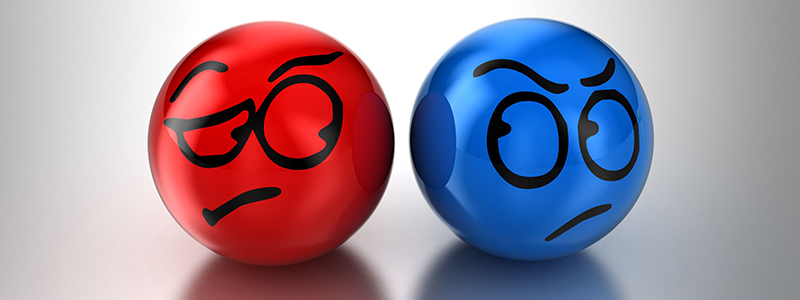إنَّ وصول الـ”أنا” إلى مرحلة البلوغ تتطلّبُ عمليةً مسبقةً للكمال، وإن عمليّةَ تحقيقِ الذّات ينبغي أن يقومَ بها الفردُ بنفسه، مّما يصعب عليه أن يستمدّها بالوسائِل الثقافيّةِ المعتادةِ التي يَمدُّها المجتمعُ، فلا يمكن تحقيقُ ذلك إلّا بعملٍ صبورٍ يشمل تعليمَ وتربيةَ الوعي ذاتيّاً، بقرارٍ من الفرد نفسِه وإرادتِه، وبصدقِهِ مع نفسِهِ ووفائِه لها.. ليكونَ “الصادقَ الأمينَ”. تخيّلَكَ إنساناً بلا دينٍ، لا أبَ ولا أمَّ لك ولا مدرسةَ وتعليمَ، وليس أمامكَ إلّا مدرسةُ الحياة فماذا تصنع؟ إذا كنتَ يتيماً .. فماذا تفعل؟ فقيراً.. ماذا تصنع؟ بل ماذا تعمل إذا صرتَ أجيراً على أموال الناس؟ ماذا تفعل.. إذا كان عملُك فقط مراقبة الأطفال طَوالَ النَّهار أو رعايةَ غنمِ آخرين؟ إذا أساء أربابُ العملِ معك وقسوا عليك وظلموك؟ إذا وُلِّيتَ عملاً وشغلت وظيفةً؟ فهل يهمُّكَ كسب المال فقط؟ إذا كان زمانُكَ بلا (دين) ولا (مذاهب)؟ أو كان ثمة بقايا (دين) لكنّه جائر ومليء بالخرافات والانحرافات والوصايات ودهاقنة الاستبداد؟ إذا هاجت حرب الفجّار (بين قريش وقيس عيلان)؟ وقومُك أهلُ شركٍ بلا (دين)، لكنّهم قاموا…