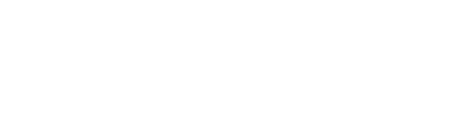لم يفق من ذهوله إلا وهو يتدحرج على الرصيف، جلس القرفصاء وسط الطريق، أسند رأسه على راحتيه، أطرق برأسه متفكراً يخاطب نفسه: ماذا جنيت؟ ألأني رفضت أن أقوم من مقعدي لرجل أبيض ضُربت ورُكلت وأُهنت وأُلقيت من الحافلة كما يلقى كيس القمامة وسط صرخات إعجاب البيض لمن فعل بي هذا؟!! جرّ أنّة طويلة عندما زفرها كاد أن يحرق لهبها وجهه، وتساءل: أهكذا تكون زفرات المقهور؟!! أخذ شريط الذكريات يطوف في مخيلته، تذكر استعمار الإنجليز لبلاده، واحتقارهم لشعبه، لاحت أمام ناظريه معاناة الهنود وهم يشيدون مدنية وحضارة بريطانيا بأجسادهم النحيلة، كيف خاضت بهم حروباً لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وعندما ظفروا في الحربين العالميتين كان الغنم لبريطانيا والغرم على الهنود. أحسّ بلسع الدموع على وجنتيه، فخالها شفرات حادّة تحفر أخاديد لها في خديه، رفع يده ليمسحها بكمه، ولكنَّ الدموع لم تكف عن الانحدار، استحى من نفسه أن يرى نفسه باكياً كطفل صغير، أو امرأة مقهورة، وقال: أتبكي الرجال يا غاندي؟!!! تفاجأ بجواب غريب انطلق من أعماق العقل والوجدان، نعم تبكي…

لمْ يُخلقِ الإنسانُ لِيشهَقَ ويزفِرَ بلْ ليحيا الحياةَ بمعانيها وبحَملٍ حقيقيٍ لمسؤولياتِها، ومِنَ العبَثِ أنْ يُحاولَ أحدُنا أنْ يُقنعَ نفسَه بغيرِ ذلكَ أوْ يسمحَ للآخرِينَ بأن يفعلوا به ذلكَ فيُستغفلُ ويُسترقُّ، بلِ الواجبُ أنْ ننطلقَ بكلِّ ما حبتْنا به الحياةُ. لِهذا، علينا أنْ نتساءلَ هل نحيا الحياةَ التي ينبغي؟ وهلْ لم يكنْ ولنْ يكونَ أفضلَ ممّا كان؟ بلْ هلْ بدأتِ الحياةُ لدينا؟ الحياةُ قوّةٌ، وبحثٌ دائمٌ عنْ مسؤوليةٍ، وتنفيذٌ جادّ لاستخلافِنا الإلهي، الحياةُ ليستْ ارتخاءً أو مساومةً، إنّها مفروضةٌ على الإنسانِ وليست اختيارًا، بهدفِ أنْ يعيشَها بما تحمِلُ الكلمةُ مِنْ معنى، فالحياةُ بطبيعتِها ليستْ ميسّرةً سهلةً، بلْ تتطلّبُ عملاً وتحمّلاً وفرحاً وحُزناً، ولو كانتْ سهلةً ميسّرةً لَما كانَ الصبرُ فيها أحدَ أبوابِ الجنةِ، والآياتُ القرآنيةُ الدالةُ على ذلك كثيرةٌ وكذلك الآياتُ التي تحُثُّ على القَبولِ الإيجابي للتكليفِ الإلهيِ والانغماسِ في أسبابِ البناءِ المسبوقةِ بالتعلّمِ وبناءِ الخبراتِ. إذنْ فالحياةُ عمليّةُ تفتُّحٍ وازدهارٍ، أيْ أخذٌ بحقٍّ وعَطاءٌ بحقٍّ، إذ الهدفُ أنْ تُستثمرَ الحياةُ في التفتّحِ بواسطةِ الأخذِ بالتَعلّمِ واكتسابِ المعارفِ الماديةِ، وتراكمِها…

قد تكون خاطرة في الطفولة تؤثر على قرارات مستقبلية خطيرة لا يرى الشخص ذاته أو المراقب له أي علاقة لهذه الخاطرة بالقرار، و يستغرب تأثيرها غير المتوقع وغير المبرر منطقياً. وقد يكون آخر قد مرَّ بنفس الظروف ولكن تأثيرها عليه وعلى قراراته المستقبلية مختلف تماماً.

من أهم أسباب شقاء الإنسان اليوم هي “الغربة” التي يعيشها مع الطبيعة، فالفجوة كبيرة بين الإنسان وأمّه “الكونية” الطبيعة، وكلما ازداد تحضراً ورقياً في مجال العلوم والتقنيات، كلما ازداد بُعداً وعقوقاً لها وأمعن في تدميرها والإساءة إليها، جاهلاً بحقوقها ومتطلباتها، وأوضح مثال على ذلك الانتهاكات البيئية واستنزاف الموارد الطبيعية والإفساد في الأرض بشتى أنواعه.

لماذا أصبحت قيمنا العليا من قبيل التسامح، والإنصاف، وحبّ الخير للآخرين، والنجدة، والكرامة، والسيادة على النفس، ونصرة المظلوم، وعلو الهمة، والعدل، والمساواة، وغيرها ممّا ينبغي أن نتمسّك بها كمن يقبض على إيمانه في الزمن الرديء (كالقابض على الجمر)، لماذا أصبحت تلك القيم في مجتمعاتنا العربية واهية، هشّة كقشر البيضة بحيث يتحتّم علينا التعامل معها بحذر شديد؟

إنّ الغاية من التشريع الديني هي ذات الغاية من التشريع الوضعي، ولو أنّنا تناولنا الدين بطريقةٍ طبيعيةٍ كما نتناول شؤوننا الدنيوية، لكان ذلك أيسر لنا وأقرب لفهم الدين، والتعاطي معه بشكل طبيعي، ولطالما أكدنا باستمرار أنّ ديننا دين الفطرة، فهو دين يتعامل مع واقع الحياة، ويستجيب لحاجياتنا الطبيعية، ولا يكلّفنا إلا وفق قابلياتنا، لأنّه يتعامل مع الواقع، فالدين يسلك بنا الطريق المناسب لطبيعتنا

لماذا صار علينا أن نصدق ما ينسب إلينا من أمور مكذوبة ونسلّم بها وكأنّها جزء من واقعنا وعقيدتنا، نفعل ذلك رغم الآثار الخطيرة التي يخلّفها التصديق بمثل هذه الأمور والتي تصل إلى حدّ تصدّع كياننا واهترائه. من هذه الأمور تأتي مسألة الجن في قائمتها، الجن ذلك العالم المجهول الذي مازال الكثير يتخبط في فهمه ومعرفته وتحديد العلاقة معه.

إن من يؤمن بأن جماعته أو مذهبه أو دينه أو فكره هو كمال الحقيقة، يجهل حكمة الله في جعل الناس شعوباً وقبائل (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم..).

المحبة هي نبتة في القلب قد تتعرّض للهزات بتأثير من تعاركات الحياة اليومية وتغيراتها ، وهي بحاجة إلى حارس أمين يضمن بقاءها في مكامن القلوب ويحفظها من الضياع ، إنه الحوار الهادئ إكسيراً للخلافات ، ذلك السلوك الحضاري الذي يدعونا أن نضع كل المسائل السهلة منها والمستعصية على طاولة حجرات العقل .

إنّ التأمّل بكيفيّة عمل “البرمجة الإنسانية”، يُؤهّلنا -بوعيٍ ناقدٍ- لوضعِ أنفسنا على صراطٍ سويّ، ويُبصّرنا بالابتعاد المحتمل لصورتنا الآدمية عن دخيلتنا التي قد تكون أيّ شيء إلاّ الآدميّة.. برنامج الإنسانية (أو الفطرة)، مغروزٌ بضمير كلّ إنسان دون تبديل له وتعديل، يوجّه أحاسيسه لفعل الخير تجاه أخيه الإنسان والتعاطف معه، متجاوزًا فوارق الصورة، والرأي، ومتجرّداً عن العلائق القرابيّة والنسبية وسائر المشتركات. كلّ البرامج العُليا (Softwares) المحمّلة فوق فطرة البرمجة الأولى (Basic) ينبغي أنْ تعمل في اتّجاهها لا ضدّها، ليَقرّ الإنسانُ إنساناً، وإلاّ ستبقى للإنسان صورتُه دون جوهر إنسانِه، وسنغدو صوَر آدميّين تستبطن قلوبَ شياطين، ليغدو ممكناً أن يُوجَد شيطانٌ أبيضُ وآخرُ أسود، وشيطانٌ مثقّف وآخر جاهل، وشيطانٌ عالمٌ وآخر تابع، وشيطانٌ مسلم وآخر يهوديّ، وشيطانٌ دينيّ وآخر علماني، وشيطانٌ يساريّ وآخر يميني وثالث وسطيّ، وشيطانٌ موالٍ وآخر معارض، وشيطانٌ عربي وآخر غربيّ، وشيطانٌ سنّي وآخر شيعيّ، وشيطانٌ بلحية وآخر بدونها، وشيطانٌ بعمامة وآخر حاسر، وشيطانةٌ بحجاب وأخرى سافرة، وشيطانةٌ إعلامية وأخرى شعبويّة، وشيطانةٌ معلّمة وأخرى طالبة…. والكلّ يهمز نفسه وغيرَه عكس البرمجة…